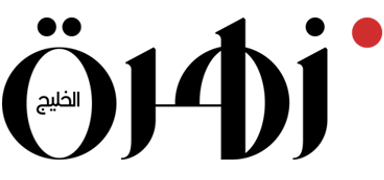كائنات مشاعل الفيصل
سعود السنعوسي 20 يونيو 2019
يختلف القراء حول اللوحات الفنية على أغلفة رواياتي، تلك الممهورة بتوقيع الفنانة المعجونة بالألوان الصارخة وجنون الملامح وأسرار التفاصيل التي تقول ولا تقول، الفنانة التشكيلية الكويتية مشاعل الفيصل.
تردني الآراء غالباً في غاية التطرف بين محب وكاره، حتى صارت أعمال مشاعل، في بعض الأحيان، بالنسبة إلى القارئ مدعاة اقتناء الرواية أو الانصراف عنها، وهو في حد ذاته من الأمور التي تجعلني أكثر تمسُّكاً بريشة مشاعل الفيصل، كتعويذة تُكرِّس الاختلاف الذي يدفع بالمُتلقي إلى التفكير. هناك دائماً اختلاف بين هيئة المرء وطباعه، وهذا هو بالضبط ما أحبه في ريشة تلك الفنانة، فهي تقدم لك شكلاً ليس بالضرورة يطابق المحتوى. شكل سهل لمحتوى معقد أو محتوى في غاية البساطة في شكل يتمنَّع عن البوح بأسراره الصغيرة. وحده المتلقي الباحث عن المعنى، ذاك الذي يجيد التأويل وقراءة التفاصيل، وحده يقف عند أعمال الفيصل، يملي النظر ويُفكِّر: ماذا تريد أن تقول هذه المجنونة الهاربة من زيف الواقع إلى حقيقة الألوان والأشكال داخل لوح الكانفاس؟
لا أخفي أنني ملعون، على ما يبدو، بلعنة أبدية بلوحات مشاعل، على أغلفة كُتبي وفي جدران البيت والمكتب وشاشة هاتفي وجهاز الكمبيوتر. لوحات تمنحني جدة اكتشاف في كل مرة أبحلق فيها، لا تبعث على ملل أو استعادة ما تعرفت إليه في نظرة سابقة، فهي مع كل نظرة إليها جديدة، تقول في كل يوم أمراً لم تبُح به أمس، كما لو أني أستبدل لوحات الجدار كل يوم، رغم أن اللوحات هي ذاتها.
لعل ما يجعلني «أُتَوئِم» كُتبي بلوحات الفيصل هو أن مشاعل لا ترسم وفق اشتراطاتي، أترك لها النص ليس من أجل رسم تفاصيله، إنما هي ترسم فهمها للنص وما لم يقله صراحة، عبر غرائبية كائناتها التي تشبه الحقيقة، تمنحني بذلك فرصة قراءة ما كتبت قراءة مختلفة. وإلى جوار ذلك فإن مشاعل وإن تميزت أعمالها التشكيلية ببصمة لا تخطئها عين، فهناك تطور دائم، تُغيِّر ولا تتغيَّر.
فرغت من كتابة رواية قصيرة في فبراير الماضي، وعلى سبيل التغيير قرَّرت أن أجيء بغلاف بعيد عن مشاعل الفيصل هذه المرة، لا سيما أنها رصَّعت روايتي السابقة «حمام الدار» بـ11 لوحة داخلية بالإضافة إلى لوحة الغلاف، على اعتبار أن بطل الرواية هو من رسمها. أردت لغلاف الرواية الجديدة أن يحتوي صورة فوتوجرافية قديمة تصور زمن أحداث الرواية، ولكنني قبل أن أدفع بالعمل إلى الناشر، وبعدما اخترت الصورة واعتمدت شكلها النهائي، تراجعت كمن أوشك على اقتراف حماقة لا تُغتفر، كيف لي أن أُصدر عملاً من دون كائنات مشاعل الفيصل؟ هاتفتها: جاهزة لعمل جديد؟ ولحسن حظي أنها أجابت على دأبها: «هات النص».
في غضون أسابيع وصلتني صورة اللوحة الخالية إلا من فتاة بدوية تحمل رضيعاً، لا تفاصيل أكثر مما تقوله عيناها التي اختزلت الرواية بأكملها!