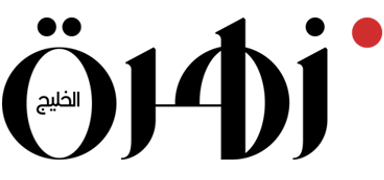#تنمية ذاتية
لاما عزت 12 مايو 2025
في كل بيت، تُروى حكاياتٌ لا تُقال، حكاياتٌ تُختزن في النظرات الصامتة، ونبرات الصوت، حينما تعلو أو تخفت، وفي الأبواب التي تُغلق بصمت، والأرواح الصغيرة التي تتعلم، مبكرًا، أن تحبس مشاعرها؛ حتى لا تكون عبئًا، فالصحة النفسية لا تُبنى فقط في العيادات، بل تبدأ من غرفة الطفل، ومن الطريقة التي يُنادى بها على اسمه، ومن الحضن الذي يسبقه الكلام، ومن الوجه الذي يُصغي دون أن يحكم. فالأمان الذي تمنحه الأسرة ليس فقط سقفًا يحمي من المطر، بل صوت داخلي، يُخبر الطفل بأن العالم ليس مخيفًا، وأنه يستحق أن يُحب، كما هو.
-

كيف تنشئ العائلة طفلاً متوازناً؟
تسلط الدكتورة وفاء البريكي، معالجة نفسية إكلينيكية في دار سند لعلاج الإدمان، التابعة لهيئة الرعاية الأسرية، الضوء على دور الأسرة في تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال والبالغين، وأهمية علاقة الطفل بوالدَيْه في بناء شخصيته وقدرته على التكيف، لاحقًا، في الحياة.
من رحم الأم تبدأ الرحلة
تشير البريكي إلى أن العلاقة بين الطفل ووالدته تبدأ حتى قبل الولادة، فتقول: «يُقال: إن رحم الأم مدرسة الطفل الأولى، ومن هناك، ودون كلمات، بلغة النبضات وحدها، يبدأ أول دروس الحياة في التشكّل. فمن خلال نبضات قلب الأم، وتوتر عضلاتها، ونوعية غذائها، يستقبل الجنين أولى إشارات الأمان، والمكان، والإنسان. فيرتبط الجنين - منذ اللحظة الأولى - بأمه، ويبدأ في اختبار الحياة عبر المعلومات الدقيقة، التي يلتقطها من حالتها النفسية والجسدية، كأنه يستشعر العالم الخارجي، من خلال حالتها الداخلية».
وتتابع: «حينما نتحدث عن (الروابط العائلية)، لا بد أن نعود إلى حيث كانت البداية خافتة، دافئة، لا تُرى.. إلى رحم الأم، حيث وُضعت أول بذرة في العلاقة الإنسانية.. فقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن الحالة النفسية للأم أثناء الحمل تؤثر - بشكل مباشر - في نمو دماغ الجنين، وتطوّر جهازه العصبي؛ حيث يمكن للتوتر المزمن، أو الاكتئاب غير المعالج، أن يترك بصماته الأولى على الطفل، حتى قبل ولادته. وهذا ما يجعل الرحم أول بيئة نفسية يتفاعل معها الإنسان، وأول علاقة عاطفية يختبر من خلالها معنى الارتباط».
وبعد الولادة، تأتي لمسات الحب الأولى، حيث يحمل الحضن، واللمس، ونبرة الصوت رسالة، مفادها: «أنت آمن.. أنت محبوب». هذه الإشارات تفرز هرمونات كالأوكسيتوسين (هرمون الحب)، لدى الأم والرضيع معًا، فتعزز مشاعر الارتباط والثقة، وهي أساس تكوين ما يُعرف بـ«نمط التعلّق»، الذي يستمر أثره مدى الحياة.
غياب الإصغاء
تؤكد البريكي أن البيت هو المكان الأول، الذي يَثْبُت في ذاكرة الطفل عن طبيعة الأماكن، ومدى ثقتنا بها، فالعائلة الآمنة تجعلنا نرى من الجدران سياجًا للبستان، و«البيوت المزعزعة» تجعلنا نرى في الجدران حديد القضبان.. تقول: «في بعض البيوت، لا تنمو الطمأنينة، بل تُخنق تحت وطأة القسوة، أو تُترك لتذبل في ظلّ التجاهل». وتوضح: الأسرة ليست فقط من تُطعم وتعلّم، بل من تُنصت وتلاحظ وترافق. وتؤكد أن الإهمال العاطفي، حتى من دون عنف، يمكن أن يترك أثرًا نفسيًا عميقًا. وتقول أيضاً: «الطفل الذي لا يجد من يسأله عن يومه، أو لا يشعر بأن دموعه تُؤخذ بجدية، قد يكبر وهو يشعر بأن وجوده لا يهم. وهذا الشعور، حينما يتراكم، يتحول إلى قلق داخلي، وصعوبات في بناء علاقات مستقبلية».
أنماط أسرية مؤذية.. بغير قصد
ما الأنماط الأسرية، التي تؤثر سلبًا في الصحة النفسية للطفل، وما العلامات التحذيرية لذلك؟.. توضح المعالجة النفسية الإكلينيكية: «الأسرة المتسلطة، التي تزرع الخوف بدل الحب، تنحت في نفس الطفل قلقًا لا يُفهم مصدره، وتُربّي طاعة مشوّهة، لا تُبنى على قناعة، بل على رعب. كأنْ يُمنع الطفل من إبداء رأيه، أو الاعتراض، ويُعاقب - بقسوة - كلما عبّر عن مشاعره، فيتعلم أن الصمت هو الطريقة الوحيدة للنجاة. أما الأسرة المتجاهلة، فتعلّمه - منذ صغره - أن احتياجاته غير مسموعة، وأن الحضور الجسدي لا يعني الحضور العاطفي، ومن ذلك أن يعود الطفل من المدرسة حزينًا، فلا يسأله أحد عن يومه، ولا ينتبه أحد إلى تغير ملامحه، أو سكونه المفاجئ. وفي الأسر المتقلبة، يتعلّم الطفل أن الحب مشروط، وأن العناق قد يتحول إلى صمت، وأن الثبات وَهْم؛ فينشأ متأرجحًا بين كفتَي الميزان؛ فتستجيب الأم أحيانًا بعطف كبير، ثم تنقلب فجأة إلى تجاهل أو غضب دون سبب واضح، ويعيش الطفل في ترقّب دائم، فلا يعرف متى يكون محبوبًا، ومتى يصبح عبئًا». وتضيف: «كل نمط غير متوازن، في التربية، يترك بصمته العاطفية على الطفل، ويظهر لاحقًا في شكل قلق، واكتئاب، واضطرابات سلوكية، أو حتى ميول إدمانية عند بعض الفئات».
-

كيف تنشئ العائلة طفلاً متوازناً؟
لكل مرحلة احتياجاتها النفسية
تشير وفاء البريكي إلى أن لكل مرحلة من مراحل النمو بابًا داخليًا، يُفتح فقط إذا فُهمت احتياجاتها بدقّة، وإذا وُجِد فيها من يرافق الطفل بوعي واتساق. ووفقًا لنظرية إريك إريكسون، فإن النمو النفسي ليس سَيرًا زمنيًا فقط، بل سلسلة من «التحديات النفسية»، التي تحتاج إلى احتواء عاطفي حتى تُثمر.
ففي الطفولة المبكرة (صفر–3 سنوات)، يكون التحدي الأساسي هو الثقة مقابل الشك.
يحتاج الطفل، هنا، إلى الأمان، وإلى استجابة حساسة ومتكررة لاحتياجاته، فلغته في هذه المرحلة حسية أكثر من كونها لفظية.
فإذا وجد في محيطه من يلبّي احتياجاته بثبات ودفء، فإنه ينمو لديه شعور داخلي بأن العالم مكان آمن، وأنه يستحق العناية. أما إذا تجاهلت الأسرة هذه الاحتياجات، فقد يتكوّن داخله شعور دائم بعدم الأمان.
وبعدها في مرحلة الطفولة المتوسطة (3–6 سنوات)، يواجه الطفل صراع المبادرة مقابل الشعور بالذنب.
في هذه المرحلة، يبدأ الطفل استكشاف العالم من حوله فيطرح الأسئلة، ويمضي للتجربة. وهنا يحتاج إلى التشجيع لا التخويف، والاحتفاء بمحاولاته لا انتصاراته،
فالطفل الذي يُقابل بالدعم عند المبادرة، ويُمنح مساحة تجربة آمنة، يتشكّل لديه شعور داخلي بالكفاءة والثقة بالنفس.
أما الطفل الذي يُقابل فضوله بالتوبيخ، وتساؤلاته بالعقاب، فيكبر وهو يحمل بداخله شعورًا غير مبرر بالذنب.
أما المراهق (12–18 عامًا)، فيدخل في صراع الهوية مقابل التشتت.
وفي مرحلة المراهقة، لا يبحث الشاب أو الفتاة عن الاهتمام فقط، بل عمن يعترف بتغيّر ملامحه الداخلية، ويراه كما هو الآن، لا كما كان أمس.
فيحتاج إلى مساحة آمنة يختبر فيها صوته، ويجرّب اختياراته دون خوف من أن يُقارن أو يُقاس بمقاييس الآخرين.
ففي هذه المرحلة، لا ينتظر من يوجّهه بصرامة، بل من يصغي إليه بعناية، ويفتح له باب الحوار، لا باب القرار.
فإن قوبل بالتفهّم والدعم، بدأ في بناء هويته بثقة واتزان. أما إن قوبل بالنقد المستمر أو المقارنة، فإنه يتوه في زحمة الآخرين، وينسى ذاته.
ولأن كل مرحلة تمهّد لما بعدها، فإن مرافقة الطفل في رحلته النفسية تحتاج إلى وعي متجدد باختلاف احتياجاته، ومرونة في طريقة الاستجابة لها.
فالتربية ليست تكرارًا لنمط ثابت، بل هي فن التحوّل برفق مع الطفل، والقدرة على التعديل والتغيير والتبديل في كل مرحلة من مراحل النمو.
حينما تهتز الحياة.. كيف تواجه الأسرة الصدمات؟
سواء كان الأمر طلاقًا أو فقدًا أو مرضًا نفسيًا أو جسديًا، تؤكد المعالجة النفسية الإكلينيكية أن الطفل لا يحتاج إلى حماية زائفة من الألم، بل إلى احتواء صادق له.. تقول: «الأهم ليس إخفاء الحقيقة، بل شرحها بلغة تناسب عمره، وبطريقة تُشعره بأنه ليس وحده؛ فالصمت حول ما يحدث يمكن أن يكون أكثر إيلامًا من الواقع ذاته. والقصص، والرسم، واللعب كلها أدوات مهمة لمساعدة الطفل على فهم مشاعره، وتفريغها». وتبين: «الطفل لا يريد من يمنعه من البكاء، بل من يقول له: أنا هنا، حتى في بكائك».
الإصغاء.. حب صامت
ختامًا.. تؤكد وفاء البريكي، المعالجة النفسية الإكلينيكية، أن الإصغاء أعظم ما تقدمه الأسرة إلى أفرادها، طفلًا أو بالغًا؛ فحينما يشعر الإنسان داخل عائلته بأنه مسموع، وبأن كلماته لا تُختصر، ولا تُعاد صياغتها، يتكون داخله شعور راسخ بأنه مرئي، ومهم، ومحبوب، فتقول: «الإصغاء بداية كل تعافٍّ، وانتماء. فمن لا يجد مكانًا عاطفيًا داخل بيته، سيبحث عنه في أماكن قد تكون أكثر ألمًا، وخطرًا». وتوجه رسالة أخيرة، قائلة: «في النهاية، لا تُقاس متانة العائلة بعدد أفرادها، بل بعمق المساحة التي يملكونها؛ ليكونوا أنفسهم؛ لأن الصحة النفسية لا تُبنى في جلسة واحدة، ولا تُرمم بعبارة عابرة. إنها تُغرس كل يوم في تفاصيل صغيرة، في السؤال الصادق، والعناق العابر، والصبر على دمعة، واحترام مشاعر لا نفهمها. فالطفل لا يحتاج إلى بيت مثالي فقط، بل إلى من يراه كما هو، ويقول له: (مكانك هنا.. في القلب!)».